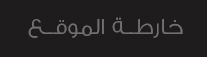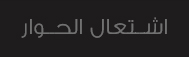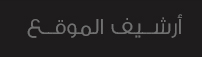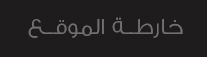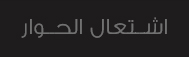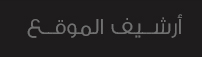|
ظاهرة التصفيق الحار… كم دقيقة تكفي للفوز بجائزة؟
هيثم مفيد
قبل نحو عقدين، كان فيلم “متاهة بان
Pan’s Labyrinth”
للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، متربعًا على عرش
الأطول تصفيقًا في مهرجانات السينما على الإطلاق، بعدما تلقى 22 دقيقة من
التصفيق في عرضه الأول بمهرجان كان السينمائي في 2006، قبل أن يخترق “صوت
هند رجب” هذا الصمت ويتلقى أكثر من 23 دقيقة من التصفيق الحار
في مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام.
كان هذا العرض بمثابة عودة نادرة إلى ما كان يعنيه التصفيق
الحار في الماضي. ولكن بعد مرور كل هذه السنوات، هل لا يزال هذا الطقس يحمل
نفس الثقل في هذه الأيام؟ وهل الجرأة الفنية والتميز الإبداعي هي ما تسمح
للأفلام بالوقوف على منصات التتويج وإلقاء خطب النصر، أم باتت تُمنح من باب
التعاطف مع الأعمال الأطول تصفيقًا؟
على مدى العقد الماضي، يزعم النقاد أننا فقدنا المعنى
الحقيقي للوقوف والتحية. إن ما كان في السابق مجرد اندفاع من الإعجاب
والتقدير لفيلم ما، أصبح يُنظر إليه الآن على أنه مقياس لقيمة الفيلم
المالية ومجرد حيلة تسويقية.
متى بدأ التصفيق وقوفًا؟
يعتبر التصفيق
“Ovation”،
المشتق من الكلمة اللاتينية
“ovatio”
التي تعني
“I rejoice”
أنا أفرح، من الطقوس الثقافية المتأصلة في عاداتنا البشرية
لدرجة أنه يُعدّ قريبًا من التصرفات اللاشعورية. ومع ذلك، فإن اختيار
الاستمرار في التصفيق – وأحيانًا الوقوف أثناء القيام بذلك – أمر مقصود
تمامًا. ولكن متى بدأ التصفيق وقوفًا؟
يعود هذا الاحتفال إلى روما القديمة. ورغم أن مجتمع اليوم
يعتبر التصفيق الحار من أسمى مظاهر الإطراء، إلا أنه في عهد الإمبراطورية
الرومانية كان من أشكال الاحتفاء بالانتصارات العسكرية الأقل شأنًا. في ذلك
الوقت، كان القادة العسكريون العائدون الذين لم تستوفِ انتصاراتهم شروط
النصر الروماني، وإن كانت لا تزال جديرة بالثناء، يُحتفى بهم بالتصفيق.
بعد بضعة قرون، ترسخت ظاهرة التصفيق الحار في الثقافة
الحديثة واعتُبر من أعظم الإطراءات في الفنون الأدائية، وقد انتشر لأول مرة
في القرن السابع عشر، عندما بدأ جمهور الأوبرا بالوقوف لتقديم التحية
للعروض الاستثنائية. حيث يحمل التينور الإسباني بلاسيدو دومينغو، الرقم
القياسي لأطول تصفيق حار في العالم بـ 101 وقفة استمرت لأكثر من 80 دقيقة
بعد أداء أوبرا عطيل في فيينا عام 1991.
بهذا الشكل، ظلت ظاهرة التصفيق الحارّ تترسخ تدريجيًا في
ثقافتنا حتى امتدت للسينما في القرن العشرين. عندما مُنح تشارلي تشابلن
جائزةً فخريةً في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1972، فإن التصفيق الحارّ
الذي استمرّ 12 دقيقةً لا يزال الأطول في تاريخ حفل جوائز الأكاديمية.
تصفيق مُدبر
في عام 1982، أعقب حفل ختام مهرجان كان السينمائي العرض
الأول لفيلم “إي تي: القادم من الفضاء البعيد
ET: The Extra Terrestrial”
للمخرج ستيفن سبيلبرغ، والذي أثار جلبة وقتها بسبب وصلة التصفيق الحار.
يتذكر المخرج الأمريكي كيف كانت مدة التصفيق تزداد مع كل إعادة سرد للأحداث
في وسائل الإعلام.
عقب عرض الفيلم، قال سبيلبرغ أن التصفيق استمر لحوالي 6
دقائق ونصف، ولكن “عند عودتي إلى لوس أنجلوس، كانت المدة قد امتدت إلى
عشرين دقيقة. فقلت: لحظة، أنا راضٍ بست دقائق. فأنا لم أتلقَّ حتى دقيقتين
من التصفيق من قبل”.
تشير هذه القصة الساخرة التي رواها سبيلبرغ، إلى أن هذه
الظاهرة ليست جديدة -كما يظن البعض- لكنها راسخة في المهرجانات السينمائية
منذ عقود طويلة؛ كما كشفت تصريحاته أيضًا أن موضة “التصفيق” لطالما شكلَّت
هاجسًا لدى وسائل الإعلام وشركات الدعاية والتوزيع. نتذكر على سبيل المثال
عبارة “الفيلم الذي نال تصفيقًا حارًا لمدة 15 دقيقة في مهرجان كان
السينمائي!”، التي كُتبت على اللوحة الإعلانية لفيلم “إكراه
Compulsion”
للمخرج ريتشارد فلايشر، عام 1959.
ربما كانت ظاهرة التصفيق الحار لا تلقى صدىً واسعًا وقتها
من جانب الجمهور، وهذا ما حد من انتشارها بشكل واسع. ولكن في أوج عصر
التسليع، حيث صرنا كبشر مجرد حفنة من الأرقام، وبات يُقاس مدى رضائنا عن
الأفلام حسب مؤشرات “الطماطم الفاسدة
Rotten Tomatoes”،
كان لابد لهذا الطقس أن يزدهر. ولكن متى وصلنا إلى نقطة التحول؟
تشير نانسي تارتاجليوني، محررة شباك التذاكر في موقع
“ديدلاين”، إلى النقطة التي تغير عندها كل شيء عندما قرر كوينتين تارانتينو
التحدث إلى الجمهور داخل مسرح غراند لوميير عقب عرض فيلمه “حدث ذات مرة في
هوليوود
Once Upon A Time In Hollywood”
عام 2019 في مهرجان كان، وهو شيء نادر، لكن الحضور استمتعوا كثيرًا بما
فعله.
هنا، رأى مدير المهرجان تييري فريمو الفرصة وقرر تنفيذ ما
يعتبر اليوم ممارسة شائعة. ففي نهاية عروض الأفلام، يتم تسليم الميكروفون
للمخرج ويُطلب من المصورين التركيز على وجوه المشاهير في الصالة. كلما كان
رد فعل الممثلين وطاقم العمل أكثر دراماتيكية، كلما زادت احتمالية استمرار
تصفيق الجمهور أكثر، وكأن المَشاهد المسرحية التي تلي الفيلم تعتبر جزءًا
أصيلاً من العرض. وهذا ما يؤكده الكاتب سكوت روكسبور في موقع “هوليوود
ريبورتر”، بأن “كثيرٌ من هؤلاء لا يُشيدون بالمزايا الفنية للفيلم، بل
يحتفون بالفنانين الحاضرين”.
ولكن متى يبدأ فعليًا قياس التصفيق الحار؟ هل عند ظهور
تترات النهاية أم عند إضاءة أضواء المسرح؟
تشير إرشادات المواقع التي تهتم بهذا النوع من الأخبار، مثل
“هوليوود ريبورتر”، و”فارايتي”، و”ديدلاين”، أن تشغيل المؤقت يبدأ لحظة
وقوف الجمهور، عادةً بعد إضاءة أضواء المسرح أو قاعة العرض، وإيقافها عندما
يبدأ معظم الحضور بالجلوس، أو عندما يُعطى مخرج الفيلم الميكروفون، ثم
يقومون بتشغيلها مرة أخرى عندما يبدأ التصفيق من جديد.
من المؤكد أن التصفيق الحار يُولّد حماسًا عامًا تجاه
الفيلم مع مشاركة مقاطع الفيديو من تلك اللحظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وعناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، لكن هذا لا يترجم دائمًا إلى نجاح
عام. تخشى الناقدة شانتيل بوزيسفيتش، من أن يؤدي التصفيق الطويل إلى رفع
التوقعات حول الفيلم، وهو أمر قد يكون له تأثير سلبي للغاية على مشواره في
موسم الجوائز.
في عام 2019، حظي فيلم “الجوكر
Joker”
بتصفيق حار لمدة ثماني دقائق في فينيسيا، وفاز بجائزتي أوسكار. في عام
2024، حظي الجزء الثاني من الفيلم “الجوكر: ثنائي الجنون
Joker: Folie à Deux”
بتصفيق حار لمدة 13 دقيقة تقريبًا، لكنه فشل على الصعيدين النقدي والتجاري.
في نهاية المطاف، ومع نظامٍ يسهل التلاعب به، غالبًا ما
يُختصر طول التصفيق الحارّ بسؤال واحد: إلى أي مدى يرغب صانع الفيلم في
استغلاله؟ إن المخرج هو من يملك خيار إنهاء هذا الطقس في أي وقت. وبعض
المخرجين، أمثال بونغ جون هو وويس أندرسون، لا يشعرون بالراحة لترك هذا
التصفيق طويلاً.
عقب العرض الأول لفيلم
“طُفيل Parasite”
للمخرج بونج جون هو، المتوج بالسعفة الذهبية، نال صناعه تصفيقًا حارًا لمدة
5 دقائق فقط بسبب قيام المخرج بمقاطعة الجمهور. وعندما تسلم الميكروفون،
قال: “دعونا جميعًا نعود إلى منازلنا”.
اقترح البعض أنه أراد ببساطة تجنب الضجة، في حين افترض
آخرون أنها كانت خطوة استراتيجية لتجنب أي خيبة أمل من النقاد بسبب التصفيق
المبالغ فيه الذي أثر على مسيرة الفيلم في موسم الجوائز. لكن الرجل صرح
لاحقًا أنه شعر بالجوع وأراد العودة للفندق لتناول العشاء، وهذه ردة فعل
طبيعية لأغلب المخرجين عقب العروض الأولى. ولكن أي كانت أسباب المخرج
الكوري الجنوبي للرحيل، فمن الضروري تذكر أن موضة التصفيق الحار اليوم
تتعلق بالأشخاص أكثر من الفيلم.
ظاهرة “صوت هند رجب”
على الرغم من أن مهرجان فينيسيا السينمائي لا يتعاطى مع
التصفيق بقدر مهرجان كان السينمائي، إلا أنه لا يزال يتمتع بتاريخ عريق في
تأكيده للظاهرة. ولكن هل يُترجم ذلك بالفعل إلى إشادة أوسع نطاقًا بعد موسم
المهرجانات؟
في العام الماضي، حطم فيلم “الغرفة المجاورة The
Room Next Door”
للمخرج بيدرو ألمودوفار، الرقم القياسي لمهرجان فينيسيا – الذي كان يحمله
سابقًا فيلم “حزانى إينيشيرين
The Banshees of Inisherin”-
بمدة تصفيق بلغت 17.5 دقيقة، لكن الفيلم لم يُطرح في نقاشات الجوائز لفترة
طويلة، باستثناء جائزة الأسد الذهبي. ومع ذلك، كان فيلم
“الوحشي The
Brutalist”
ثاني أكثر الأفلام استحسانًا من حيث عداد التصفيق، قد حصد جائزة الأسد
الفضي كأفضل مخرج، وفاز عنه أدريان برودي بجائزة أوسكار أفضل ممثل.
خلال نسخة هذا العام، اقترب فيلما “إنجيل آن لي
The Testament of Ann Lee”
و”آلة التهشيم The
Smashing Machine”
من الرقم القياسي، حيث أذهلا المشاهدين بأكثر من 15 دقيقة من التصفيق لكل
منهما. تأثرت النجمة أماندا سيفريد حتى البكاء من هذا الرد، مستمتعةً
باللحظة بتقدير وتواضع واضحين. كما حظي أحدث أعمال المخرج غييرمو ديل تورو
“فرانكنشتاين
Frankenstein”،
بطولة أوسكار إيزاك وميا جوث وجاكوب إلوردي، بنحو 15 دقيقة من التصفيق، مما
غمر الممثلين الرئيسيين بالامتنان.
ولكن “صوت هند رجب”، بات الفيلم الأطول تصفيقًا على
الإطلاق، ليس في فينيسيا وحسب، وإنما في مهرجان كان أيضًا، متخطيًا حاجز
الـ 23 دقيقة. وذكرت مجلة “فارايتي” أن التصفيق استمر حتى بعد إطفاء أنوار
المسرح.
المُلفت في نسخة هذا العام، أن “صوت هند رجب” -الأطول من
حيث التصفيق- لم يتوج بالأسد الذهبي كما حدث مع فيلم ألمودوفار العام
الماضي، واكتفى بجائزة مهمة أخرى، وهي جائزة لجنة التحكيم الكبرى. في حين
نال الأمريكي جيم جارموش الجائزة الأولى عن فيلمه
“أب
أم أخت أخ Father
Mother Sister Brother”،
على الرغم من حصوله على دقائق تصفيق محدودة لم تتجاوز 6 دقائق.
في حين أن عداد التصفيق الخاص بالمواقع الكبرى، تجاهل
أفلامًا أخرى لم يأتِ على ذكرها نالت جوائز مهمة، مثل “تحت السحاب
Below the clouds”
الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفيلم “في العمل
At Work”
الفائز بجائزة أفضل سيناريو، والفيلم الصيني “الشمس تشرق علينا جميعنا
The sun rises on us all”
المتوج بجائزة أفضل ممثلة.
في الأخير، قد تنجرف عواطفنا في رياح التصفيق الحار التي
باتت تعصف بمهرجانات السينما الكبرى، ولكن يجدر بنا أن نشكك في التقارير
التي تُصاحب هذه التصفيقات -المستحقة نسبيًا- فأغلبها ليس جديرًا فحسب، بل
مُدبَّرٌ من نواحٍ عديدة. فالنقاشات حول السينما لا يمكن اختزالها في
أرقامهما، بل ينبغي أن تعكس أحاديثنا مدى شغفنا بهذا الفن خلال هذه
التظاهرات السينمائية الكبرى. |