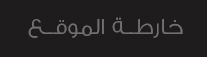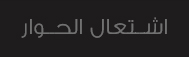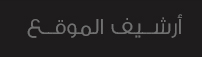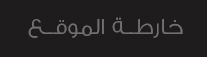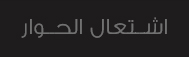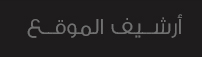|
يوم قابلتُ جيم جارموش
هوفيك حبشيان
في مطلع هذا العام، بلغ جيم جارموش عامه الثاني والسبعين.
عند هذا العمر، كان ديفيد لينتش قد طوى مسيرته السينمائية، بعد أن منح
العالم أبرز روائعه. أما ديفيد بووي، فقد غادرنا إلى العالم الآخر وهو دون
السبعين. في نهاية الأسبوع الماضي، نال جارموش جائزة «الأسد الذهبي» في
مهرجان البندقية الثاني والثمانين، عن فيلمه الجديد
«أب
أم أخ أخت»،
من يد مواطنه ألكسندر باين. قرأتُ تعليقًا لأحدهم اعتبر فيه الجائزة مجرد
محاولة «لإنعاشه» فنيًا، بعد سلسلة أفلام لم ترقَ إلى مستوى أعماله الأولى
لا بل ساهمت في أفول نجمه. قد لا يكون هذا التوصيف دقيقًا، لكنه بالتأكيد
يلامس جانبًا من الحقيقة.
يقول السيناريست غييرمو أرياغا إن الإلهام عند الفنّان ليس
معينًا لا ينضب، بقدر ما هو طاقة قد تنفد مع الوقت، شأنه شأن الوقود في
خزان السيارة. ولعلّ هذا ما أصاب جارموش،
الذي يقدّم في عمله الأحدث ثلاث حكايات عن ثلاث عائلات في ثلاثة فصول
متّصلة. نصّ بصري جيّد من حيث الصنعة، لكن السؤال: هل «الجيد» كافٍ حين
نتحدّث عن سينمائي بحجمه؟ الفيلم يحمل بصمته، لكن من دون تلك اللمعة التي
كانت تميز أفلامه القديمة، التي أقامت توازنًا دقيقّا بين العبثي والذهني،
بين الكوميديا السوداء والتأمّل الوجودي.
مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن خلف هذا الاسم ذي الحرفين الأولين
المتشابهين، يقف فنّان كبير، صاحب رؤية خاصة للعالم. كان ولا يزال من أعمدة
السينما الأميركية المستقلّة، تلك التي ترى في هوليوود مرتعًا للمال
والسلطة والمافيات، أكثر منها حاضنة للفنّ.
صنع جارموش «حالة» سينمائية، بأسلوب إخراجي يجمع بين
الأناقة والعمق، بين السكون والحسّ الجمالي المتدفّق. حوّل نصوصه، عبر
رؤيته الخاصة، إلى أفلام مشبّعة بالحساسية والمرونة، تنساب في حركة متأنية.
هذا العاشق الأبدي للموسيقى والكتب والسينما الأوروبية واليابانية (من
غودار إلى ميزوغوتشي) لا ينتمي إلى زمن بعينه أو إلى جغرافيا محدّدة. هو من
الذين لا تستنزفهم الموضة. اسمه مرتبط بتجربة جمالية قائمة على استعادة
المعنى الأصلي لعبارة «السينمائي المؤلّف».
«أفلامي
ليست سردية بالمعنى الأدبي، هي موسيقية في تكوينها. هناك نغمة وإيقاع. أحبّ
أن يتأسس الفيلم على شكل ما، أن يتنفّس ضمن قوانين، لكن أكثر ما يشدّني
أيضًا هو خرق تلك القوانين وتجاوزها بلطف»، قال ذات مرة في أحد الدروس
السينمائية التي تابعتها.
رسم جارموش بورتريهًا معتّمًا لأميركا، متوغّلًا في عمقها
ومتاهاتها وتناقضاتها.التقط دفء البشر وإرباكهم، وارتقى باللحظات العابرة
إلى صور موحية تختزل قلق الوجود. قد تمرّ تلك اللحظات في غابة يلفّها ضباب
مطر باكر، أو على متن طائرة، أو في غرفة فندق تنبعث منها رائحة وحدة ثقيلة.
اصطحبنا من مدينة إلى أخرى ليبرهن أن بعض الرحلات لا تغيّرنا، لكنها تضعنا
وجهًا لوجه أمام شريط الحياة والذكريات واحتمالات السعادة المؤجّلة. هذا
كله موجود في أفلامه. لم أختلق شيئًا.
جارموش من السينمائيين الذين جسّدوا الهامشية على الشاشة.
شخوصه، وإن اختلفوا، يتشاركون حجم القسوة الذي تعاملهم به الحياة، وغالبًا
ما يُقصَون عن خيرات العالم، مهمّشين، منسيّين، مكلومين، متروكين… من «رجل
ميت» (1994) إلى «غوست دوغ» (1999)، مرورًا بـ «قطار غامض» (1989)، يشقّ
سؤال الهوية طريقه في سينما هذا المهووس بتفكيك الطبيعة البشرية. فشل
التواصل هو الآخر من المشتركات بين شخصياته، رغم تنوّعها الظاهري وتباين
دوافعها. يعرف جارموش أن الإنسان غير قابل للإصلاح، ومع ذلك، لا يتخلّى
عنه. في ذلك اللقاء البعيد الذي جمعني به في المغرب، اعترف لي، بصوته
الهادئ ونظرته المراوغة: «أجمل ما في الحبّ أن تشعر بالملل وأنت في صحبة
مَن تحب».
للمناسبة، قبل نحو خمسة عشر عامًا، جمعتني به جلسة خلال
حضوره مهرجان مراكش. كان حديثه، كما أفلامه، ممتلئًا بالفكر والرؤية وفلسفة
الحياة. كان آنذاك في منتصف الخمسينات. تحدّث يومها عن السينما كما لو كان
يتحدّث عن طقس روحي، بعيدًا من القيود الصناعية التي تكبّلها. بدا لي
واضحًا أن الفنّ في اعتباره ليس مهنة، إنما أسلوب حياة وعلاقة شغف دائمة مع
كلّ ما هو إنساني وجوهري.
تجربته الطويلة مع المصوّر روبي موللر (1940 – 2018) أضحت
نقطة مهمة في حديثنا يومها. هكذا رواها: «كنّا نعمل كثيرًا قبل التصوير،
نتشارك الأفكار، نبحث عن مَشاهد، صور، شذرات من الحياة. هكذا نخلق الإلهام.
لكن كنا نمارس تقنية غريبة: عندما نرى شيئًا يدهشنا، نُعرض عنه. لا نصوّره،
بل نذهب إلى نقيضه. إذا كانت أمامنا شجرة عملاقة تثير إعجابنا، نبحث عن
شجرة صغيرة ونصوّرها. لم نطارد الجمال الظاهري، إنما كشف ما خلفه».
كان الحديث في ذلك اليوم انطلاقًا من «حدود التحكّم»، أحد
أفلامه الأقل شهرةً. سألته عن التكرار في الفيلم، فرد بالقول: «أحب الأشياء
التي تتكرر، لكن ليس بالشكل نفسه. يدهشني أن يحدث تبديل صغير مع كلّ تكرار».
عند جارموش، التفاوت الخلاّق بينه وبين الآخرين هو ما يطلق
العنان لمخيلته. لطالما كرر مقولة: «من الصعب أن تتيه عندما لا تعرف أين
تذهب». يجد فيها حرية ترتبط بالحالة الذهنية أكثر من ارتباطها بالمكان.
ما هو جميل في الفنّ، وفق تعريفه، أنه لا يأتيه بما يعرفه،
إنما بما لم يفكّر فيه من قبل. إنه الفنّ الذي يربكك، بدلًا من ذاك الذي
يؤكّد لك أفكارك المسبقة. يقول: «أحب أن يهزّني العمل الفنّي في العمق، مثل
أفلام كيارستمي أو لوحات فرنسيس بايكون. لا أحب أن يُعامَل المُشاهد كغبي
فيُقال له: تفضّل، إليك ما تريد. هذا النوع من الإرضاء السطحي يثير سخطي».
حتى الموسيقى التي هي مصدر الوحي الأول عنده، لا يحتمل أن تملي على
المُشاهد ما يجب أن يشعر به. «أكره الفنّ الذي يصرخ في وجهك: اشعر الآن».
يعترف انه حاول طوال حياته أن يكون نفسه فقط. لا يقاوم
الإغراءات ببطولة، إنما برغبة عميقة في ألا يتلّوث. وعندما يقول عنه الناس
إنه مصمّم على إنجاز الأشياء التي يحبّها والمضي فيها قدمًا، يدهمه إحساس
بالفخر. فأكثر ما يؤلمه في هذا العالم اللعين هو أن الناس يسيرون كقطيع خلف
ما يُعتقَد أنه الحقيقة. «كلّ شيء يُقاس ويُحدَّد، حتى الأحاسيس. إني أؤمن
أن خيالك هو ضميرك، بل موهبتك الربانية، وهو ما يجعلك أنتَ. لا أحد يمكنه
أن يملي عليك خيالك».
في عالمنا اليوم، أكنّا في أميركا أو في أي مكان من العالم،
الديانة الحقيقية في نظره هي المال: «المال هو السلطة الجديدة، اللغة
الوحيدة، الإله المعاصر. أما أنا، فديانتي هي الخيال والإدراك. الشاعر
الإنجليزي ويليام بلايك، وهو أحد مثلي العليا، قال إن تقدير أي شيء بالمال
يجب أن يُعدّ خطيئة. وأنا أعتقد أن هذه أكبر خطيئة نرتكبها يوميًا. إسأل
نفسك: كم تساوي كلّ هذه الطيور التي تزقزق من حولنا؟ مَن يستطيع أن يضع
سعرًا لضوء الشمس؟ أو لحظة حديث صادق مع عزيز وأنتما تحتسيان الشاي؟ هذا هو
المأسوي في زمننا: نحن فقدنا القدرة على التقدير الحقيقي».
حين كان في العشرين، انتقل جارموش إلى باريس ليلتحق بجامعة،
لكنه وجد نفسه في السينماتك الفرنسية التي فتحت أمامه احتمالات لا تُعد.
هكذا بنى ثقافته السينمائية. كثيرًا ما يُسأل عن الأفلام التي أثّرت به،
ولا يملك جوابًا محدّدًا. يؤكّد إن أكثر من ثلاثمئة مخرج تركوا بصمة في
داخله.
عندما تتمادى قليلًا في شرح أحد أفلامه وتصر على معرفة
الشاردة والواردة، يرد بأنه لا يملك أدوات تحليلية تجاه أعماله. «إني
تلميذٌ أكثر من كوني أستاذًا. أتعلّم. أتأمّل. أراقب. أسعد بأنني أفعل ما
أفعله، لكن لا أجرؤ على دعوة الآخرين إلى تقليدي. هذا يتعارض مع فلسفتي. لا
أقدّم وصفات جاهزة. أحب فكرة «لطريق»، الرحلة كحالة سردية. منذ هوميروس
ودانتي، كانت رواية الطريق أفضل طريقة لرواية القصص. السينما التي أحبّها
تسير على هذا النحو. كما قال أمير كوستوريتسا: هناك مَن يصنع الأفلام لأنه
مندهش بالسينما، وهناك مَن يصنعها كنوع من التمرد عليها. أنا من النوع
الأول. عملي كمخرج أشبه بصحن لاقط، وأنا الوعاء. أجمع من هنا وهناك: فكرة،
مَشهد، تفصيلة، لوحة. ومع الوقت، يُولد خط العمل ومحركه. لا أعرف كيف تحدث
هذه «الولادة»، ولا أظن أن أحدًا يعرف. الخلق الفنّي سرّ غامض. يشبه طفلًا
يرسم بلا وعي، ثم تكتشف أن ما رسمه له ملامح فيل».
لا يشاهد جارموش أفلامه بعد إنجازها. لا يجد في ذلك فائدة،
مستخدمًا مقولة لبول فاليري: «القصيدة لا تنتهي، بل تُهمَل». في نظره، هذا
ينطبق على السينما أيضًا، الفيلم لا يكتمل. نتركه، نمضي، ويبدأ هو رحلته
الخاصة. تمامًا كما هذا المقال عن
JJ. |