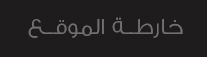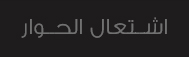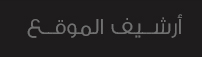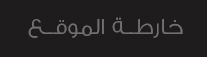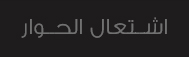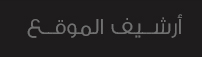|
وثائقي يرصد نضال حركة “فلسطين أكشن” في بريطانيا..
قراءة في فيلم “لتحطيم آلة الحرب”
إسلام السيد
في لحظة تاريخية فاصلة، تتقاطع فيها السياسة مع الفن
والمقاومة مع التجريم، تظهر نوعية من الأفلام مثل “تحطيم آلة الحرب”
(To Kill a War Machine)
في لحظات يائسة، لتكون شاهدا على محاولة السينما الوثائقية في مواجهة آلة
الحرب والقمع، وإن كانت فقط قادرة على تقديم سردية مضادة تُطمس.
هذا الفيلم أخرجته حنان مجيد و”ريتشارد يورك”، وأنتجته
“مجموعة قوس قزح”
(Rainbow Collective)
، وهو لا يكتفي بتوثيق أنشطة “حركة فلسطين”
(Palestine Action)
البريطانية، بل يمارس مناهضة سياسية نُشاهد تبعاتها، لا سيما بعد قرار
البرلمان البريطاني في 2 يوليو 2025 تجريم الحركة، فسحب المنتجون النسخة
الإلكترونية من الفيلم مؤقتا، ومنعوا كل عروضه الأخرى حتى إشعار آخر.
يحمل ذلك مخاطرة قانونية في ظل التعسّف ضد كل شكل من أشكال
مناهضة الحرب على غزّة، لكنه يطرح تساؤلات جوهرية حول دور السينما
الوثائقية في زمن الأزمات، لا سيما في ظل جريمة إنسانية تحدث في فلسطين،
والعالم والمسار القانوني والدولي يقفان أمام ذلك، ما بين التواطؤ والصمت،
أو رد الفعل المحدود على أقصى تقدير.
فهل يمكن أن يجد هامشا جانبيا من حرية التعبير، يكون الفاعل
فيه الموازنة بين الفن والنشاط السياسي؟
إن المشروع السينمائي هنا يتجاوز كونه مجرد عمل فني، ليتجسد
بيانا سياسيا، يتحدى السرديات الرسمية، ويقدم سردية مضادة للسردية السائدة.
كيف تُقاوم آلة الحرب؟
لفهم السياق الذي يتحرك فيه الفيلم، لا بد من ذكر حيثيات
وجود “حركة فلسطين”، التي تأسست في يوليو/ تموز 2020 على يد هدى عموري، وهي
ناشطة بريطانية من أصل فلسطيني وعراقي، و”ريتشارد بارنارد” الناشط اليساري.
هدى عمّوري و”ريتشارد بارنارد”، المؤسسان المشاركان في حركة
“فلسطين أكشن”
جاءت الحركة استجابة لتصاعد العنف في فلسطين، بهدف مواجهة
الشركات في المملكة المتحدة، التي تزود إسرائيل بالسلاح والتقنيات
العسكرية، وتسعى الحركة إلى تعطيل سلاسل الإمداد العسكرية، والضغط على
الشركات المتواطئة في الصراع.
وتشمل أساليبها مجموعة متنوعة من أدوات المناهضة، بداية من
الاعتصام على أسطح مصانع الأسلحة، إلى أعمال التخريب مثل كسر النوافذ ورش
المباني بالطلاء الأحمر، ثم التعطيل المباشر لخطوط الإنتاج، وإتلاف المعدات
العسكرية.
رشّ مقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بطلاء أحمر،
وسط تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في لندن. احتجاجا على تغطيتها للصراع
الإسرائيلي الفلسطيني، وقد انتقد بعض المشاهدين “بي بي سي”، لرأيهم أن
تغطيتها غير متوازنة بما فيه الكفاية
تتخذ هذه المناورات قيمتها الأخلاقية من قدرتها على التطرف،
ويبرر ذلك مستوى كارثية ما تناهضه. وتتضمن أنشطتها أعمالا دعائية رمزية،
منها استهداف مواقع تاريخية مرتبطة بالاستعمار البريطاني في فلسطين، كما
حدث لمقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في 2025، فغُطي المبنى
بالطلاء الأحمر، احتجاجا على ما رآه النشطاء انحيازا لإسرائيل.
اتجاه الذاكرة المضادة
يُفتتح فيلم “تحطيم آلة الحرب” بأغنية “إن أن” لثنائي الراب
“شاب جديد”و “وضبور”، وهما فنانان فلسطينيان تمحورت أغانيهما حول الحياة
اليومية في فلسطين، ولا يعتمدان في تعاونهما أو عملهما منفردين على الأحداث
الكبيرة، بقدر ما تعكس أغانيهما هموما يومية وذاتية.
مع ذلك، فإن هذه الأغنية بالتوازي مع تسجيلات مجموعة
“الموقف الفلسطيني” وهي تقتحم مصنع سلاح بالمملكة المتحدة، مثّلتا تمازجا
نوعيا، يقدّم الوضع الفلسطيني كأن لديه قدرة ما، لا ترتبط به مباشرة،
لكنّها جزء من حقه في ظل ما يناله من قتل دائم.
تستعيد هذه القوة فكرة أخلاقية مطموسة تماما في حياتنا
المعاصرة، ولعلها مُتكررة تاريخيا، وهي وجود صوت موضوعي يستطيع التحيّز
للشأن الفلسطيني، ويستطيع أن يقول علينا أن نوقف قتل المدنيين بشتّى الطرق،
بما فيها الطرق العنيفة والمانعة.
اشتباك مع موقف الحركة
يتناول الفيلم نشاط الحركة بحوارات متعددة مع الناشطين بها،
وأولياء أمور المعتقلين على إثر نشاطهم بها، وكيف أسسوا أدوات مناهضة
مُغايرة، لا تقوم فقط على الإدانة الخطابية، بل تحاول أن تستخدم العنف في
اتجاه مُبرر، يجعل قتل الفلسطينين شيئا يجب التفكير بشتّى الطرق لإيقافه.
يوازي الفيلم بين تسجيلات من قلب قطاع غزة، وأخرى من الضفة
الغربية، متعلقة باعتداءات من الاحتلال تعود إلى عام 2020، وفي فضاء صوتي
صاخب ومتنوّع، يعرض أغنيات عربية عدة معنيّة بالشأن ذاته.
يقدم الفيلم سردية متشابكة قائمة على العبور الإنساني
وتجاوز الفروق العقدية، فنحن أمام هذا الفيلم لا نشاهد عرضا خطيا تقريريا،
بل تُستعاد الأحداث بأثر رجعي، لبناء سجل تاريخي يقوم على انتقاء أرشيفي
مكثف، تتبيّن به الرواية التي يحتاجها العالم، أو عليه أن يترك تجاهلها
وطمسها.
تكمن إحدى نقاط قوة الفيلم في مباشرته، وفي الاشتباك الحاد
مع موقف الحركة من الشأن الفلسطيني، إذ يعبر جميعهم عن ضرورة التفكير في
وسائل دائمة، تدفع العالم إلى التفكير فيما يحدث للفلسطينيين.
يشمل ذلك تصدير العنف، وتعطيل موارد التسليح وتحطيمها،
وتصوير هذه الممارسات لوضعها في إطارها المُحدد، وهو مناهضة قتل
الفلسطينيين، لأنها بطبيعة الحال عُرضة للتجريم دائما.
النشطاء الفاعلون الساردون
لا يبدو المحتجون هنا مجرد مخربين، بل هم أفراد يجمعهم سياق
مُشترك في الحديث، وتضامن أخلاقي جماعي يُبرر المخاطرة المستندة على موقف
جماعي وإيمان ضروري بالإنحياز، ويقف هذا التوجه أمام التمثيل الإعلامي
السائد، الذي غالبا ما يسطح الوضع الفلسطيني، ويحركه من إبادة وتهجير إلى
“صراع”.
كذلك تظهر الدوافع الأخلاقية والإنسانية وراء التخريب
وتصدير العنف على أنه نوع من المقاومة، بالاشتباك المباشر مع الفاعلين في
الحركة، فنراهم واعين بهذه الأفعال، وتحديد حيثيات ممارستها، وتوقيت ذلك،
وكيف يمكن الضغط بها لإبراز صوت آخر مضاد للسائد.
تأخذ الأفعال العنيفة هنا بُعدا جدليا يضعها في مساحة
إشكالية، فهي من الجهة القانونية تلاقي ما لاقت الحركة، فتنتهي بالإدانة
القانونية والإدراج ضمن قوائم الإرهاب، فتُمنع من وجودها الشرعي، وتكون
وجودا موصوما بشعارات ترهيب مُستهلكة. ومن جهة أخرى، يتمثّل في تصدير العنف
-كما يوضح الفيلم- أسلوب من التعبير له ضرورته.
مُخرجا الفيلم حنان مجيد و”ريتشارد يورك” صانعا أفلام
معروفان في مجال حقوق الإنسان، قدّما فيلما عن عمال النسيج في بنغلاديش، هو
فيلم “دموع على القماش”
(Tears in the Fabric)
عام 2014، وقد جمعا المواد لهذا الفيلم من شبكات النشطاء ومواقع التواصل،
ليضعا النشطاء في موقع الفاعلين والساردين في آن.
الانحياز فنيا وأخلاقيا
يتخذ فيلم “تحطيم آلة الحرب” موقفا واضحا من الأحداث التي
يوثقها، رافضا الادعاء بالحياد أو الموضوعية المزعومة، على عكس الجهات
الدولية والإعلامية، التي تفتعل اتخاذ موقف، وتسطح فِعل الإبادة، وترواغه
لغويا بمفردات مثل “الصراع”.
يختار الفيلم أن يُظهر انحيازه بوضوح، فيرفض مسافة التقرير
الموضوعي، ويقدم النظر عن قرب في مسائل التمييز العرقي وحيثيات الإبادة،
والضرورة المشتركة للعمل الجماعي.
يأخذ هذا الانحياز ضرورته من الحق الفلسطيني في أن يكون
مرئيا، لا أنه إحصائية رقمية، أو قتيل محتمل، أو إرهابي حين يخرج عن صمته،
بل هو مُمثّل لوجود إنساني أصيل، له حق في الأرض والحياة وتحديد المصير.
نشطاء من حركة “فلسطين أكشن” يسكبون الطلاء ويحطمون
النوافذ، أثناء احتجاجهم على سطح مصنع محركات الطائرات المسيرة المحدودة في
شينستون، ليتشفيلد، وسط إنجلترا
ولذلك لا يحاول الفيلم إبراز السردية الأخرى، بوصفها فقط
حقيقة غائبة، بقدر ما هي أيضا في حاجة إلى إقحام المشاهد، ليكون جزءا من
بنية تُدين الوجود الإنساني جُملة.
يظهر ذلك في تأسيس الفيلم بأسلوب ديناميكي ومتقطع، فينتقل
بين الحوارات ولقطات النشطاء وهم يحطمون النوافذ ويتسلقون الأسطح، وإعلانات
شركة التصنيع المُسلّح “إلبيت”، التي تتباهى بالدقة في منتجها، تتبعها
لقطات ضبابية مروعة لأطفال ضحايا تلك الدقة.
تاريخ من الاحتجاج المنظم
لا يمكن فهم “حركة فلسطين” وفيلم “تحطيم آلة الحرب” إلا
بوضعهما في سياق العلاقة مع تاريخ أوسع، في إطار تقليد طويل من حركات
المقاومة التي استهدفت صناعة الأسلحة، فقد شهد التاريخ حركات مماثلة،
اعتمدت العمل المباشر والتخريب المحدود وسيلة للاحتجاج على الإنتاج
والتصدير للأسلحة المستخدمة في قمع الشعوب.
ومن أبرز تلك العمليات ما فعل نشطاء “بلوشيرز”
(Plowshares)
عام 1980، حين دخلوا مصنعا لصناعة القنابل النووية في ولاية نيويورك،
وكسروا المعدات، ورشوا الدم على الآلات احتجاجا على تطوير الأسلحة النووية.
اعتُقل النشطاء وحوكموا، وحُكم عليهم بالسجن زمنا طويلا،
لكنهم اتخذوا المحاكم منصة لتوضيح موقفهم الأخلاقي والسياسي. وقد أدت هذه
الأعمال دورا في زيادة الوعي العام بالأسلحة النووية، وطرحت تساؤلات
أخلاقية حول إنتاج الأسلحة، وضلوع الأنظمة الكُبرى الحالية في تصدير واسع
للعنف.
محاصرة نظام الفصل العنصري
في سياق أكثر قربا من الشأن الفلسطيني، وخلال الفصل العنصري
في جنوب أفريقيا، مارست حركات مدنية ضغطا شديدا على الشركات الغربية، التي
زودت الدولة بالأسلحة.
تأسست مجموعات صغيرة متخصصة في العمل المباشر ضد مصانع
الأسلحة والمخازن العسكرية، مع التركيز على منع تصدير الأسلحة التي تُستخدم
لقمع السكان السود.
كانت هذه الحملة جزءا من نضال أوسع ضد نظام الفصل العنصري،
وأظهرت أن المجتمع المدني يمكن أن يؤدي دورا حاسما في تغيير السياسات
الحكومية.
شملت أساليب هذه المجموعات اقتحامات صغيرة لمصانع الأسلحة
وتحطيمها، ونشر تقارير وأشرطة فيديو إلى المجتمع الدولي، لإظهار صلة
الشركات الغربية بالقمع العنصري، والضغط على المصارف والمؤسسات المالية،
لوقف تمويل الشركات المصنعة للأسلحة.
مواجهة الأنظمة القمعية
نجد عبر الفيلم أن الاعتراض القائم على تصدير عُنف مماثل،
لإثبات موقف سياسي وأخلاقي يقوم على التضامن، كان حاضرا في التاريخ الحديث،
وعبر سياقات شتى.
فخلال السبعينيات والثمانينيات، واجه عمّال في أمريكا
اللاتينية أنظمة سياسية قمعية، كانت ضد صورة مقاربة للأنظمة السياسية
والشركات العابرة للقارات، المتواطئة معها في الشأن الفلسطيني.
شملت عمليات الاحتجاج وتحطيم الآلات مصانع المعدات الثقيلة
وتصنيع الأسلحة، وتعاظم حضورها بسبب رد الفعل القمعي تجاهها، وكوّنت
مجموعات يسارية مسلّحة وشبه مسلحة، رأت تخريب الآلات والمعدات وسيلة فاعلة
للتعبير والرفض.
سردية السينما الوثائقية
يمثّل فيلم “تحطيم آلة الحرب” نموذجا مُلتزما للسينما
الوثائقية، التي تُحاول المشاركة في صنع سردية على يسار مجريات تفاعل أنظمة
العالم الأول وقطاعه الخاص، الذي يرتكز على دعم ممارسة إبادية، بتجاهله
الأخلاقي، وتواطؤه الجماعي.
ينطلق الفيلم من فكرة تُقدّر مأساة الشأن الفلسطيني حاليا،
وهي ضرورة الانحياز لصوت كتيم. يحضر المُنتج الفنّي المُشبّع بالمادة
السياسية، ليؤكد قيمة هذه الأداة في مثل هذه الأوقات، التي تحتاج إلى كل
أشكال التسليح الممكنة، لإحداث تغير اجتماعي، مهما كان ضئيلا.
لا يعد هذا التغير بالضرورة ذا تأثير مباشر ولحظي، لكنه
تأثير يظل محفوظا للتاريخ صوتا آخر، يعيدنا إلى التفكير في علاقة الوضع
الفلسطيني بتواريخ تُشبهه، وأخرى تشترك معه في ضرورة استخدام العنف أداة
للتعبير.
فحين يُحاول الفيلم أن يضع ما يلقاه الفلسطينيون في إطار
تاريخي أوسع، ينتج سردية تُقاوم السردية السائدة، من حيث توجيه النظر إلى
الفلسطينين بعين إنسانية، تُدرجه ضمن حركة التاريخ، بدلا من إقصائه في عدّة
أطر سطحية، تُشكّلها خطابات وإدانات آمنة، أما فعل القتل فيظل مستمرا، وله
مُبرراته المدجّنة.
وعلى مستوى تاريخي، ينفتح موضوع الفيلم على المجال
التاريخي، فيربطنا بحراكات مُشابهة حدثت في سياقات شتى، تتعلق بالعرق
والصراع الطبقي والحقوق العمالية.
يفتح ذلك سياقا أوسع لفهم الوضع الفلسطيني، الذي يعود إلى
سياق طويل من الاعتداء، يجعلنا نُفكّر في علاقة النظام العالمي الحالي
وروابطه الاقتصادية المتمثلة في القطاع الخاص، وأي علاقة تجمع هذه الأطراف
بصور وتنويعات من الاعتداء والقمع المؤسسي.
ناقد سينمائي مصري. |